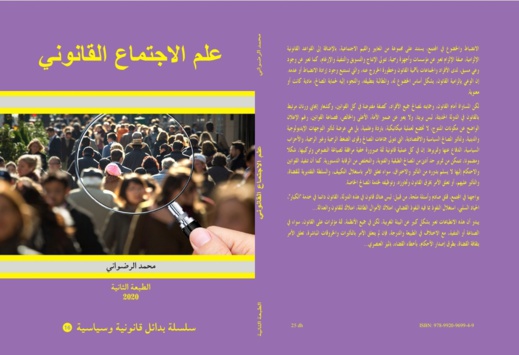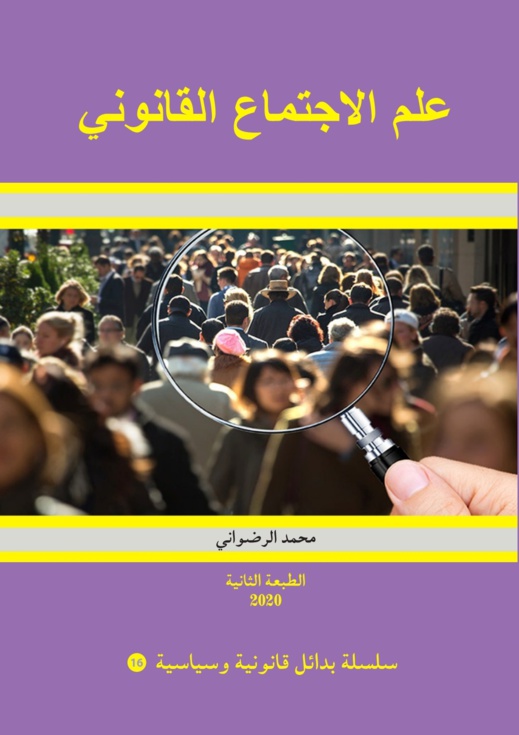ناظورسيتي
اصدر استاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الناظور، الدكتور محمد الرضواني، طبعة 2020 لكتاب علم الاجتماع القانوني.
ويعد الكتاب، مرجعا مهما للباحثين في العلوم السياسية، اذ يملء الفراغ الذي تركته بعض الدراسات، لاسيما المتربطة منها بعلم الاجتماع القانوتي.
ويشير تقديم الكتاب الى انه بالرغم من بعض الدراسات التأسيسية لاسيما نصوص نجيب بودربالة وبول باسكون وجود دوبري، إلا أن علم الاجتماع القانوني ظل شبه غائب في كليات الآداب وكليات الحقوق المغربية، ذلك أن هيمنة التصور القائم على تجاهل الواقع الاجتماعي والتشبث "بالنص" في الجامعة المغربية، خصوصا الدراسات القانونية، واتخاذ إفراغ الدراسات والأبحاث في قوالب جاهزة، منهجا؛ وتقليد النماذج المرجعية في هذا الصدد، والتشبث بالقانون كما هو قائم، والحذر من أي اختراق من قبل العلوم الأخرى، واجترار القوالب، والنماذج الأبوية.. كان من الأسباب المباشرة في تغييب عدد من المواد الحيوية من الجامعة المغربية؛ كفلسفة القانون، والأنتروبولوجيا السياسية، وسوسيولوجيا القانون، بالرغم من أهميتها والامكانيات التي تفتحها أمام الأكاديميين والسياسيين على حد سواء للإجابة عن أسئلة المجتمع.
وإذا كانت المقاربة السوسيولوجية للقانون، أخذت مكانة هامة داخل الدول الغربية، سواء في الحقلين: البيداغوجي والأكاديمي، أو على مستويي: اقتراح البرامج وصناعة السياسات العامة، فإن وضعية هذه المقاربة في الحقلين الثقافي والأكاديمي المغربيين، تبدو ضعيفة وهامشية، فبالإضافة إلى غياب شبه تام لنصوص ومؤلفات تعرف بسوسيولوجيا القانون، يسجل قلة الدراسات العلمية المنهجية حول الظاهرة القانونية في المجتمع المغربي، رغم التغيرات السوسيولوجية التي عرفها، والتي تفرض نفسها في هذا الإطار.
وتأتي هذه الدراسة للتعريف بهذا الفرع، وإثارة أهميته، وتبيان الآفاق الإيجابية التي يفتحها أمام الأكاديمي والسياسي على حد سواء، والتي لا يمكن الإيمان والإحساس بها، إلا بمزيد من النقاش في هذا الصدد.
يسجل الكاتب في مقدمة المؤلف: "الانضباط والخضوع في المجتمع، يستند على مجموعة من المعايير والقيم الاجتماعية، بالإضافة إلى القواعد القانونية الإلزامية، صفة الإلزام تعبر عن مؤسسات وأجهزة رسمية، تتولى الإنتاج والتسويق والتنفيذ والإرغام، كما تعبر عن وجود وعي مسبق، لدى الأفراد والجماعات بأهمية القانون وخطورة الخروج عنه، والتي تستتبع وجود إرادة الانضباط أو عدمه. إن الوعي بإلزامية القانون، يشكل أساس الخضوع له، والمطالبة بتطبيقه، واللجوء إليه لحماية المصالح، مادية كانت أو معنوية.
لكن المساواة أمام القانون، وحمايته لمصالح جميع الأفراد، كصفة مفترضة في كل القوانين، وكشعار إيجابي ورنان مرتبط بالقانون في الدولة الحديثة، ليس بريئا، ولا يعبر عن ضمير الأمة، الأعلى والخالص، فصناعة القوانين، رغم الإعلان الواضح عن مكونات المنتوج، لا تخضع لعملية ميكانيكية، باردة وعلمية، بل هي عرضة لتأثير التوجهات الإيديولوجية والدينية، ولتأثير المصالح السياسية والاقتصادية، التي تتولى جماعات المصالح وقوى الضغط الرسمية وغير الرسمية، والأحزاب السياسية، الدفاع عنها وتمريرها. إن في كل عملية قانونية ثمة صيرورة خفية مرافقة لصياغة النصوص وتركيبها، شكلا ومضمونا، تتمكن من تمرير حد أدنى من المصالح الطبقية والفئوية، والتخلص من الرقابة الدستورية. كما أن تنفيذ القوانين والاحتكام إليها لا يسلم بدوره من التأثير والاختراق، سواء تعلق الأمر باستغلال التكييف، والسلطة التقديرية للقضاة، والتأثير عليهم، أو تعلق الأمر بخرق القانون وتجاوزه، وتوظيفه لخدمة المصالح الخاصة.
يواجهنا في المجتمع، قلق صادم وأسئلة ملحة، من قبيل: ليس هناك قانون في هذه الدولة، القانون دائما في خدمة "الكبار"، الحياد السلبي، استغلال النفوذ بما فيه النفوذ القضائي، امتلاك الأموال الطائلة، امتلاك للقانون والعدالة...
يبدو أن هذه الانطباعات تعبر بشكل كبير عن البيئة المغربية، لكن في جميع الأنظمة، ثمة مؤثرات على القانون، سواء في الصناعة أو التنفيذ، مع الاختلاف في الطبيعة والدرجة، فإن لم يتعلق الأمر بالتأثيرات والخروقات المباشرة، تعلق الأمر بثقافة القضاة، بطرق إصدار الأحكام، بأخطاء القضاء، بالميز العنصري...
إن الوعي بالقانون والاحتجاج به يعبر عن أهميته في الضبط الاجتماعي، وفي توجيه سلوك الأفراد داخل المجتمع، لكن الأفراد لا ينصاعون فقط إلى القانون، بل ينضبطون لمجموعة من المعايير والقيم الاجتماعية، كالعادات والأعراف والأخلاق والمثل العليا، والدين؛ انضباط ناتج بالدرجة الأولى عن التنشئة الاجتماعية، التي تقوم بها مختلف مؤسسات التنشئة: الأسرة، جماعة الأصدقاء، المدرسة، المؤسسات الدينية، الجمعيات، الرأي العام...، أكثر مما هو ناتج عن الخوف والإلزام. بل أكثر من ذلك، يطور الأفراد في معاملاتهم قواعد ومبادئ غير رسمية، لكنها ملزمة، منفصلة عن القانون الرسمي، لكنها تعد بمثابة قواعد "قانونية" مجتمعية.
فالقانون ليس الأداة الوحيدة لتوجيه سلوك الأفراد وضبطه، وصفة الإلزام ليست المسؤولة الوحيدة عن إرادة احترام القانون، إذ تفاعل أدوات التنشئة الاجتماعية، التي تمكن من تمرير المعايير الاجتماعية واكتساب الأفراد للقيم الثقافية، مع القواعد القانونية، تجعل الانضباط واحترام القيم والمعايير بمختلف أشكالها، في كثير من الأحيان، عملية طوعية.
إن مختلف الجوانب المثارة في هذا الصدد، رغم اختلافها تعبر عن حقيقة واضحة، ألا وهي أن القانون ليس بناء منفصلا، ولا نصوصا متقنة الصياغة، محايدة بالمطلق ومستقلة تمام الاستقلال، خلال إعدادها وتنفيذها، فالقيم السياسية والايديولوجية والاقتصادية والدينية، تبقى حاضرة، لأن القانون نتاج المجتمع ولأجله كان.
تعدد العناصر التي يثيرها القانون، تقود إلى تعدد جوانب دراسته واختلافها، فالتعالي عن الظروف الزمنية والمكانية وتجاهل الواقع، والاهتمام بالقانون كفكرة مجردة، والبحث في أهدافه السامية، والانشغال بالقانون الأمثل، يحيل على الجانب الفلسفي. والبحث في اختلاف القوانين من زمن إلى آخر، وتطورها عبر التاريخ، ومقارنة القوانين مقارنة زمنية، يدل على الجانب التاريخي. والاهتمام بالبناء القانوني، والتركيز على تفسير النصوص القانونية، ودراستها دراسة داخلية، يحيل على علم القانون.
وكل فرع من هذه الفروع ينطلق من منظور خاص، ويعتمد على أدوات منهجية متميزة، ولكل فرع مقاربته الخاصة، كما لكل مقاربة محدوديتها ونواقصها، فلا المقاربة الفلسفية ولا القانونية ولا التاريخية، تحيط بمختلف الأبعاد الاجتماعية التي يثيرها القانون.
لذلك تأتي المقاربة السوسيولوجية، لتركز بمنظور وأدوات منهجية متميزة، على تفاعل القانون كظاهرة اجتماعية، مع مختلف النظم والظواهر الاجتماعية، والتي فرضت نفسها في الدول الغربية، رغم تأخر ظهورها ونشأتها".
اصدر استاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الناظور، الدكتور محمد الرضواني، طبعة 2020 لكتاب علم الاجتماع القانوني.
ويعد الكتاب، مرجعا مهما للباحثين في العلوم السياسية، اذ يملء الفراغ الذي تركته بعض الدراسات، لاسيما المتربطة منها بعلم الاجتماع القانوتي.
ويشير تقديم الكتاب الى انه بالرغم من بعض الدراسات التأسيسية لاسيما نصوص نجيب بودربالة وبول باسكون وجود دوبري، إلا أن علم الاجتماع القانوني ظل شبه غائب في كليات الآداب وكليات الحقوق المغربية، ذلك أن هيمنة التصور القائم على تجاهل الواقع الاجتماعي والتشبث "بالنص" في الجامعة المغربية، خصوصا الدراسات القانونية، واتخاذ إفراغ الدراسات والأبحاث في قوالب جاهزة، منهجا؛ وتقليد النماذج المرجعية في هذا الصدد، والتشبث بالقانون كما هو قائم، والحذر من أي اختراق من قبل العلوم الأخرى، واجترار القوالب، والنماذج الأبوية.. كان من الأسباب المباشرة في تغييب عدد من المواد الحيوية من الجامعة المغربية؛ كفلسفة القانون، والأنتروبولوجيا السياسية، وسوسيولوجيا القانون، بالرغم من أهميتها والامكانيات التي تفتحها أمام الأكاديميين والسياسيين على حد سواء للإجابة عن أسئلة المجتمع.
وإذا كانت المقاربة السوسيولوجية للقانون، أخذت مكانة هامة داخل الدول الغربية، سواء في الحقلين: البيداغوجي والأكاديمي، أو على مستويي: اقتراح البرامج وصناعة السياسات العامة، فإن وضعية هذه المقاربة في الحقلين الثقافي والأكاديمي المغربيين، تبدو ضعيفة وهامشية، فبالإضافة إلى غياب شبه تام لنصوص ومؤلفات تعرف بسوسيولوجيا القانون، يسجل قلة الدراسات العلمية المنهجية حول الظاهرة القانونية في المجتمع المغربي، رغم التغيرات السوسيولوجية التي عرفها، والتي تفرض نفسها في هذا الإطار.
وتأتي هذه الدراسة للتعريف بهذا الفرع، وإثارة أهميته، وتبيان الآفاق الإيجابية التي يفتحها أمام الأكاديمي والسياسي على حد سواء، والتي لا يمكن الإيمان والإحساس بها، إلا بمزيد من النقاش في هذا الصدد.
يسجل الكاتب في مقدمة المؤلف: "الانضباط والخضوع في المجتمع، يستند على مجموعة من المعايير والقيم الاجتماعية، بالإضافة إلى القواعد القانونية الإلزامية، صفة الإلزام تعبر عن مؤسسات وأجهزة رسمية، تتولى الإنتاج والتسويق والتنفيذ والإرغام، كما تعبر عن وجود وعي مسبق، لدى الأفراد والجماعات بأهمية القانون وخطورة الخروج عنه، والتي تستتبع وجود إرادة الانضباط أو عدمه. إن الوعي بإلزامية القانون، يشكل أساس الخضوع له، والمطالبة بتطبيقه، واللجوء إليه لحماية المصالح، مادية كانت أو معنوية.
لكن المساواة أمام القانون، وحمايته لمصالح جميع الأفراد، كصفة مفترضة في كل القوانين، وكشعار إيجابي ورنان مرتبط بالقانون في الدولة الحديثة، ليس بريئا، ولا يعبر عن ضمير الأمة، الأعلى والخالص، فصناعة القوانين، رغم الإعلان الواضح عن مكونات المنتوج، لا تخضع لعملية ميكانيكية، باردة وعلمية، بل هي عرضة لتأثير التوجهات الإيديولوجية والدينية، ولتأثير المصالح السياسية والاقتصادية، التي تتولى جماعات المصالح وقوى الضغط الرسمية وغير الرسمية، والأحزاب السياسية، الدفاع عنها وتمريرها. إن في كل عملية قانونية ثمة صيرورة خفية مرافقة لصياغة النصوص وتركيبها، شكلا ومضمونا، تتمكن من تمرير حد أدنى من المصالح الطبقية والفئوية، والتخلص من الرقابة الدستورية. كما أن تنفيذ القوانين والاحتكام إليها لا يسلم بدوره من التأثير والاختراق، سواء تعلق الأمر باستغلال التكييف، والسلطة التقديرية للقضاة، والتأثير عليهم، أو تعلق الأمر بخرق القانون وتجاوزه، وتوظيفه لخدمة المصالح الخاصة.
يواجهنا في المجتمع، قلق صادم وأسئلة ملحة، من قبيل: ليس هناك قانون في هذه الدولة، القانون دائما في خدمة "الكبار"، الحياد السلبي، استغلال النفوذ بما فيه النفوذ القضائي، امتلاك الأموال الطائلة، امتلاك للقانون والعدالة...
يبدو أن هذه الانطباعات تعبر بشكل كبير عن البيئة المغربية، لكن في جميع الأنظمة، ثمة مؤثرات على القانون، سواء في الصناعة أو التنفيذ، مع الاختلاف في الطبيعة والدرجة، فإن لم يتعلق الأمر بالتأثيرات والخروقات المباشرة، تعلق الأمر بثقافة القضاة، بطرق إصدار الأحكام، بأخطاء القضاء، بالميز العنصري...
إن الوعي بالقانون والاحتجاج به يعبر عن أهميته في الضبط الاجتماعي، وفي توجيه سلوك الأفراد داخل المجتمع، لكن الأفراد لا ينصاعون فقط إلى القانون، بل ينضبطون لمجموعة من المعايير والقيم الاجتماعية، كالعادات والأعراف والأخلاق والمثل العليا، والدين؛ انضباط ناتج بالدرجة الأولى عن التنشئة الاجتماعية، التي تقوم بها مختلف مؤسسات التنشئة: الأسرة، جماعة الأصدقاء، المدرسة، المؤسسات الدينية، الجمعيات، الرأي العام...، أكثر مما هو ناتج عن الخوف والإلزام. بل أكثر من ذلك، يطور الأفراد في معاملاتهم قواعد ومبادئ غير رسمية، لكنها ملزمة، منفصلة عن القانون الرسمي، لكنها تعد بمثابة قواعد "قانونية" مجتمعية.
فالقانون ليس الأداة الوحيدة لتوجيه سلوك الأفراد وضبطه، وصفة الإلزام ليست المسؤولة الوحيدة عن إرادة احترام القانون، إذ تفاعل أدوات التنشئة الاجتماعية، التي تمكن من تمرير المعايير الاجتماعية واكتساب الأفراد للقيم الثقافية، مع القواعد القانونية، تجعل الانضباط واحترام القيم والمعايير بمختلف أشكالها، في كثير من الأحيان، عملية طوعية.
إن مختلف الجوانب المثارة في هذا الصدد، رغم اختلافها تعبر عن حقيقة واضحة، ألا وهي أن القانون ليس بناء منفصلا، ولا نصوصا متقنة الصياغة، محايدة بالمطلق ومستقلة تمام الاستقلال، خلال إعدادها وتنفيذها، فالقيم السياسية والايديولوجية والاقتصادية والدينية، تبقى حاضرة، لأن القانون نتاج المجتمع ولأجله كان.
تعدد العناصر التي يثيرها القانون، تقود إلى تعدد جوانب دراسته واختلافها، فالتعالي عن الظروف الزمنية والمكانية وتجاهل الواقع، والاهتمام بالقانون كفكرة مجردة، والبحث في أهدافه السامية، والانشغال بالقانون الأمثل، يحيل على الجانب الفلسفي. والبحث في اختلاف القوانين من زمن إلى آخر، وتطورها عبر التاريخ، ومقارنة القوانين مقارنة زمنية، يدل على الجانب التاريخي. والاهتمام بالبناء القانوني، والتركيز على تفسير النصوص القانونية، ودراستها دراسة داخلية، يحيل على علم القانون.
وكل فرع من هذه الفروع ينطلق من منظور خاص، ويعتمد على أدوات منهجية متميزة، ولكل فرع مقاربته الخاصة، كما لكل مقاربة محدوديتها ونواقصها، فلا المقاربة الفلسفية ولا القانونية ولا التاريخية، تحيط بمختلف الأبعاد الاجتماعية التي يثيرها القانون.
لذلك تأتي المقاربة السوسيولوجية، لتركز بمنظور وأدوات منهجية متميزة، على تفاعل القانون كظاهرة اجتماعية، مع مختلف النظم والظواهر الاجتماعية، والتي فرضت نفسها في الدول الغربية، رغم تأخر ظهورها ونشأتها".

 محمد الرضواني يصدر الطبعة الثانية لكتاب علم الاجتماع القانوني
محمد الرضواني يصدر الطبعة الثانية لكتاب علم الاجتماع القانوني